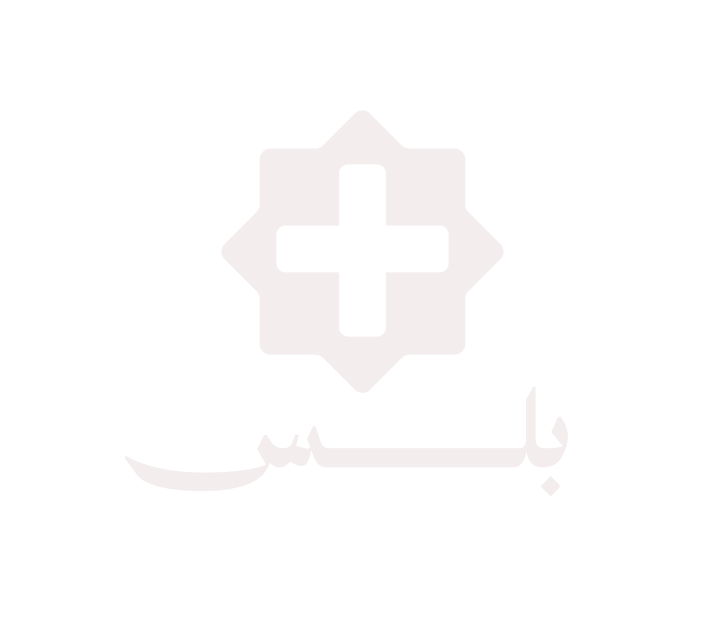ترتكز السياسة الإيرانية في الداخل على شعار “الموت لإسرائيل، الموت لأميركا”، بوصفه نسغ الشرعية الثورية التي يقوم عليها النظام الخميني. وتترجم السياسة الإيرانية هذا الشعار، في الإقليم، على قيادة “محور المقاومة والممانعة”، أي النفخ في نار الحرب وإدامتها إلى يوم القيامة، خارج الحدود الإيرانية بالطبع. وتعمد في سبيل ذلك، إلى إخراج جماعة أهلية أو مذهبية من كنف الرابطة الوطنية وتمكينها من نفسها سلاحاً ومالاً ومرافق خدمات وموارد اقتصادية، وشبكة علاقات مستقلة عن دولتها، وإنشاء فضاء سياسي متخيل وأيديولوجي يفصلها تماماً عن الجماعات الأخرى، التي تشاركها الهوية القومية. وتنيط بهذه الجماعة مهمة “المقاومة” التي ستأتي بـ “الموت لأميركا، الموت لإسرائيل”.
وحصدت إيران من هذه السياسة نفوذاً قوياً في العراق واليمن والبحرين ولبنان وفلسطين وسوريا. نفوذ يقوم على تصديع المجتمعات والهيمنة عليها بواسطة “نظام الحرب الأهلية -الإقليمية” الباردة أو الفاترة أو المتأججة جحيماً وتدميراً.
فنظام الحرب الأهلية هو توأم “المقاومة” وثمرتها الوحيدة طوال العقود المنصرمة. واهتدت إيران الخمينية إلى هذا “الابتكار” السياسي، بُعيد اضطرار الخميني لـ”شرب كأس السم” والقبول بوقف الحرب “المقدسة” ضد صدام حسين، التي كانت تمده بشرعية تصدير الثورة تحت عنوان “إسقاط الطواغيت”. كان حليف إيران، حافظ الأسد، هو الذي هندس وصقل هذه الفكرة الجهنمية: إدارة وتدبير نظام الحرب الأهلية، خارج الحدود، داخل الجماعات الفلسطينية واللبنانية (والكردية التركية).
وأصل فكرة “المقاومة والممانعة” ونظام الحرب الأهلية – الإقليمية، بالمعنى الميداني والإجرائي والاستثمار السياسي، يعود بداية إلى توسل جمال عبد الناصر، بعد هزيمة حزيران 1967، حرباً استنزافية ضد إسرائيل استمرت حتى العام 1970.
فقد انتهت تلك الحرب على عكس المتوخى منها، إذ تكرس التفوق الإسرائيلي واستنزفت مصر وأُنهكت وأُفقر شعبها، بالتوازي مع تفاقم القمع ضد المعارضات اليسارية والإسلامية (الإخوان المسلمون) وضد الحركات الطلابية والعمالية، كما ترجحت سمة الاستبداد على باقي سمات نظام جمال عبد الناصر، خصوصاً بعد توسع الجيش في الهيمنة على المجتمع وموارده، وتعاظم “مؤسسة” السجن السياسي، وعلى هذا المذهب وهذه المآلات، اتجهت سوريا “البعث” منذ انقلاب 1966، وخصوصاً بعد مؤتمر الحزب الحاكم عام 1968.
وإنكاراً لهزيمة 1967 وتداعياتها، تلقفت مصر الناصرية وسوريا البعثية انطلاقة الكفاح المسلح الفلسطيني، وفق عقيدة “الحرب الشعبية طويلة الأمد” المستلهمة من النموذجين الجزائري والفيتنامي، كوسيلة عسكرية وسياسية تشكل رداً استراتيجياً على الاحتلال الإسرائيلي. فدعمت مصر وسوريا هذه الانطلاقة بكل الوسائل الممكنة. وكان الأردن الذي يملك الحدود الأطول مع فلسطين، ويتواجد فيه العدد الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين، والشريك “الاضطراري” في الحرب والهزيمة، هو قاعدة انطلاق تلك العمليات الفلسطينية “الفدائية”.
منح هذا التحول في سياسة المواجهة مع إسرائيل كل من مصر وسوريا مخرجاً من الحرب المباشرة وتبعاتها التي لا تُحتمل، وخفف عن الدولتين أعباء التسليح وكلفة بناء جيوش حديثة ومحترفة، من دون التخلي عن ادعاء المواجهة والصمود والتصدي والمقاومة، فدعم التنظيمات الفلسطينية المسلحة جدد “الشرعية الثورية” للنظامين الناصري والبعثي، أي شرعية التحرر الوطني ومحاربة الاستعمار، ولاحقاً مقاومة “الإمبريالية والصهيونية”.
وعلى هذا المنوال تبنت الأنظمة العسكرية العربية الأخرى من الجزائر إلى ليبيا والسودان واليمن والعراق تلك الأيديولوجيا ولو لفظياً معظم الأحيان، والتي تبرر تأجيل (أو فشل) مشاريع التنمية والتحديث واستحقاقات التعليم والصحة، وتبرر حجز المجتمع وتكبيله ومنعه عن السياسة والنقد والمساءلة، وإلقاء كل مسؤولية على العدو والخارج المتآمر.
هكذا استراحت مصر وسوريا من واجب المساءلة عما حدث في حزيران المشؤوم، وتهرب النظامان من استحقاقات المراجعة السياسية لأسباب تلك الهزيمة التاريخية، تحت شعار “لا صوت يعلو فوق صوت المعركة”. وهكذا أيضاً ظهرت الملامح الأولى لنظام الحرب اللانهائية، وبالواسطة.
كان عام 1970 حاسماً في مصير الشرق الأوسط وتحولاته. إذ أفضى الكفاح الفلسطيني المسلح وظاهرة “الفدائيين” وعقيدة المقاومة الشعبية، إلى فقدان السيطرة على الحدود وتعاظم الفلتان الميلشياوي داخل الأردن، وتكاثرت التنظيمات المسلحة التي باتت تمارس التفجيرات وخطف الطائرات حول العالم، ما هدد جدياً الدولة الأردنية ونظامها الملكي، لتندلع “حرب أهلية” مصغرة، هي نتيجة حتمية للتعارض الجوهري بين “سيادة الدولة” و”عقيدة السلاح” (أو “المقاومة”).