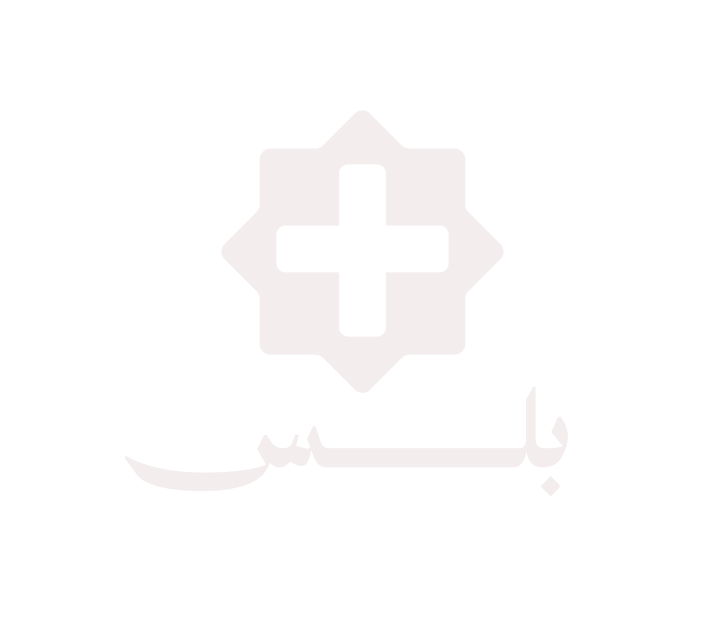كنا نحبه كثيراً، فقد كان دائم الابتسام والضحك، كان صديقاً للجميع، ورغم ذلك لم نستطع الصلاة عليه في الجامع تحت وطأة القصف الهيستيري وتحليق طيران الاستطلاع يومها، حتى أهله، زوجته، أولاده وإخوته لم يتمكنوا من وداعه، لم تشفِ أمه غليل الفقد بالضم والشم وري الجسد الساخن بالدمع الكثيف، فقد جرى كل شيء على عجالة، من لحظة موته، ولغاية دفنه الذي تكفل به عمال من المجلس المحلي في المدينة لوحدهم، داخل ما سمي بالروضة، (المقبرة الجماعية التي أنشأها المجلس المحلي من طبقات، لكي تتسع للأعداد الهائلة من الشهداء اليوميين)، وإنه لمن الحظ أن يموت المرء شهيداً في تلك البقعة من الأرض، إذ لا وقت لغسيل جسده ولا ماء، وأحياناً لا مكان أيضاً.
هذه القصة التي يرويها أحد السوريين الناجين من مذابح الغوطة تبدو قطعة بازل في مشهد كامل، قوامه روايات عن موت سوري غير مكتمل، موت لم يعاش، ينبعث منه القلق، ويصبح ألماً قاتلاً على مائدة السوريين مضافاً إلى قائمة سيل الآلام التي يتجرعونها كل يوم، فهل يرتاح المدفون في جزيرة غريبة في اليونان وحيداً دون اسم ولا شاهدة قبر حتى؟ هل يرتاح أهله؟ هل يقتنع محبو من هام جسده داخل قاع البحر فلم يحظ سوى بنظرات الهلع المتبادلة مع من بقي أو غرق عند اللحظات الأخيرة للغرق، أثناء رحلة الهرب من جحيم سوري؟! حيث لم يتردد البحر في ارتكاب ذات الجرم الذي ترتكبه الأفرع الأمنية مع السوريين المعتقلين وذويهم، مبتلعاً الجسد ومعلقاً أرواح من ماتوا داخله، هل يقتنعون بهذه النهاية التعيسة وبهذا المستقر السائل؟.
هل يكتفي الذي في سوريا بوداع أخير على السكايب لابنه في تركيا، أو الأردن، أو ألمانيا، أو بلغاريا؟، هل يطمئن من تمّم مراسم الموت والتشييع بالأمس، ووقفت اليوم روحه متأهبة لحراسة قبور قد تنبش بأي لحظة من قبل عصابات النظام؟، هؤلاء الذين منعوا أيضاً كل يوم وكل ساعة إقامة شعائر الحزن، وإعلان موت الأحبة، والبكاء بصوت عالٍ، منعوا اللقاءات الأخيرة، ولحظات الوداع، منعوا الحياة عن السوريين قبلاً ثم منعوا عنهم الموت. أي راحة سيعيشها من هُجّر وقد ترك وراءه كل قبور الأحبة.
وهكذا يتحول الموت إلى جريمة اختفت أدلتها بفعل فاعل، وتتواطأ هنا على الميت وذويه كل الجغرافيا وعوامل الطبيعة والمسافات والوقت والظرف السوري القاهر والعجز والعدالة الدنيوية أيضاً، إذ يصبح اختيار القبر، ونوع الورد والكفن وموقع الدفن وساعته ولون التراب والجمل التي ستكتب فوق الشاهدة وحجمها ونوع رخامها، حقاً محجوباً على السوريين، يخرج من طور البداهة لينضوي في سياق الحقوق التي يقاتل ويُقتل السوريون لأجلها، وبهذا يقدر عليهم بسبب كل هذه القسوة أن يخوضوا حرباً يومية من أجل موتهم من أجل موت كموت الآخرين لا نهايات مفتوحة ولا تداعيات قاتلة له.
في أسطورة موت أدونيس السوري تبكي النائحات بكاءً غزيراً، وتتحول دموع حبيبته من فرط النواح عليه بعد رؤية جثته إلى أزهار بيضاء، وتستمر في الندب عليه مع جموع الباكيات مرددةً جملتها الشهيرة: آيلينوس، ويلي عليك يا ولدي، ويلي عليك يا دامو، كل الأشياء تبكي معي، مهددةً بترك العالم والعيش في العالم السفلي مع أدونيس، فتخاف الآلهة من زوال جمال هذا العالم، وتعقد مجمع الآلهة، وتقرر عودة الإله إلى عالم البشر، ليقضي النصف الأول من العام معها.
يبدو هذا الكلام منفصلاً اليوم عن سياقه السوري طالما أن السوريين محرومون حتى من الموت، وطالما أن هوية الموت بالنسبة للسوريين قد تغيرت فإذا كان هناك موت كامل بما يحمل من معنى عند شعوب العالم، فإنه الآن بالنسبة للسوريين الرواية الناقصة مبتورة الآخرة، وعذابات طويلة الأمد لا تنتهي إلا بموت آخر غير مكتمل أيضاً ربما. بالرغم من أن السوريين صبغوا أنهاراً بلون الدم، وأنبتوا الشقائق الحمر في كل سوريا، ولكن أحداً منهم لم يتسنّ له أن ينوح ليحيي من يحب كما يجب.