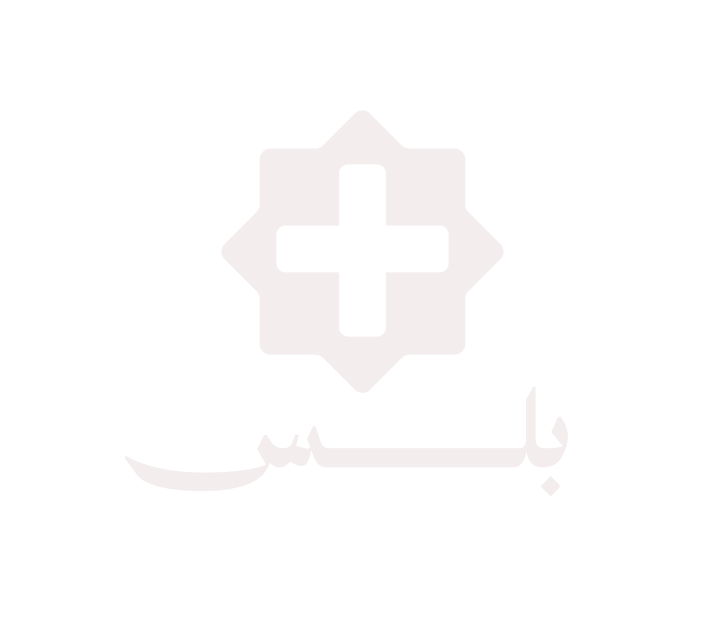الثورة السورية هي ثورة فقراء وليست ثورة كرامة، هي ثورة إسلاميين ضد حكم علماني وليست ثورة مواطنة.. هذا بالضبط ما تريد الميديا الغربية الوصول إليه وتأكيده وترسيخه في ذهن المواطن الغربي، بعد أن اطمأنت إلى أن توصيف الحرب الأهلية الذي أطلقته على الحدث السوري قد استقر تماماً في أذهان قرائها، ولكن ذلك ليس كل شيء، فالتفاصيل الأخرى أشد وأكبر في مغالطاتها المتعمدة والتي سنتجرأ أن نطلق عليها من الآن فصاعداً المغالطات مقبوضة الثمن..
الحلقة الثالثة
عن الأسد “العلماني” والثورة “السلفية”!
يعتقد قارئ البحث الهولندي أن خطورة ما يطرحه تتوقف فقط عند المسميات الخادعة التي يتبناها في توصيف الحدث السوري والتي تم استعراض بعضها في الحلقتين السابقتين من هذا البحث، ولكن ثمة ما هو أخطر بكثير، ففي استعراضه للمدن السورية، يصف البحث الهولندي مدينة الرقة على أنها عاصمة الدولة الإسلامية، صياغة الجملة باللغة الهولندية توحي بالحياد، فيما تترك الصياغة الأثر الذي تسعى إلى تكريسه في أذهان القراء، وهو أن الدولة الإسلامية هي حقيقة ناصعة لا تستدعي البحث في مكوناتها وأهدافها والجهات الحقيقية التي تقف وراءها وتدعمها وتشغلها وتوجهها.
ولتأكيد ذلك التصور يصف البحث تلك الدولة الإسلامية بأنها مكونة من المجموعات الإسلامية “السنية” المتشددة، وهو أسهل التوصيفات وأكثرها سذاجة، وخاصة إن أخذنا الفترة الزمنية بعين النظر، ففي العام ٢٠١٦ “زمن كتابة البحث” كان سر الدولة الإسلامية قد تكشف تماماً، على الأقل من خلال النتائج التي حققها، فالملاحظة التي لا يمكن أن تغيب عن ذهن الباحث هي أن التنظيم “السني” لم يقتل سوى المواطنين “السنة” الثائرين ضد الأسد، بالإضافة إلى محاربته للجيش الحر والذي اعتبره عدوه الأول منذ لحظة دخوله إلى سورية، وقدم أكبر الخدمات لنظام العصابة، سواء من خلال تصفية خصوم الأسد العسكريين والمدنيين في الداخل، -وأحيانا في الخارج- أو من خلال الرواية التي استهدفت الخارج تحديداً وهي التأكيد على أن نظام الأسد يحارب الإرهاب..
إن توصيف التنظيم بتلك الطريقة يتقاطع تماماً مع رواية الأسد وحلفائه، ولا يتقاطع من قريب أو بعيد مع الحقائق، وهاهنا يبدو البحث متطوعاً لتأكيد رواية العصابة وترسيخها في أذهان المجتمع الأوروبي، بعدما استطاع التنظيم أن يقنع الكثير من السوريين بأن نظام الأسد أفضل ممن سيخلفه، وذلك واضح تماماً في نموذج “الرقة” وما تلاها من المدن التي استلمها التنظيم فيما بعد.
يمر البحث أيضاً على مدينة دمشق في إطار رصده للمدن السورية، فيذكر بشكل عابر الهجوم بالسلاح الكيماوي على الغوطة، ولكنه يقول بالحرف بأن المدينة شهدت في العام ٢٠١٣ هجوماً بالسلاح الكيماوي، وينتهي الكلام عند هذا الحد بدون أدنى تلميح إلى الفاعل، ولا حتى إلى الاتهامات التي وجهت للأسد باستعمال ذلك السلاح.
قد يقول قائل إن البحث يتوخى الموضوعية فلا يريد أن يطلق حقائق لا تستند إلى معلومات دقيقة، وأن الهجوم الكيماوي على الغوطة لا يزال مجهول الفاعل بالنسبة للغرب الذي لا يمتلك معلومات كافية ولا يريد أن يتورط باتهام طرف، وهنا لا يمكن إلا أن نتساءل: فلماذا يوافق البحث إذن على رواية واحدة حول تنظيم داعش رغم كل ما طرح من روايات نقيضة عن ارتباط التنظيم بالنظام وبإيران؟ ولماذا يختبئ البحث خلف الموضوعية فقط في النقاط التي تدعم رواية الأسد، فيما يتحدث بلغة اليقين عما سواها؟ وبحسابات المنطق والمعطيات والنتائج والمصالح والمستفيد، نجد أن الهجوم الكيماوي لا يمكن أن تقوم به جهة أخرى غير عصابة الأسد، وبالاستناد إلى ذات المرجع سنجد أن تنظيم داعش لم يخدم سوى نظام الأسد، فأية بلادة تلك التي تجعل صحفيين بحجم كتاب هذا البحث لا يلتفتون إلى الحدود الدنيا من المنطق الذي يقود إلى الحقيقة؟ وهل يمكن أن نفسر هذا الاستسهال إلا بالتواطئ مدفوع الثمن؟
وفي مروره على تاريخ حافظ الأسد، يتظاهر البحث بالهجوم على الأخير من خلال طريقة استيلائه على الحكم وإقامته للحكم العسكري الديكتاتوري، غير أنه يصف الأسد الأب بأنه أقام حكماً “علمانياً” وبالتالي استطاعت الأقليات المسيحية والطوائف الأخرى أن تعيش بسلام في سورية.
سيبدو التعاطف مع الأسد هاهنا فكرة شديدة الوضوح، فالغرب يمكن أن يتصالح مع فكرة الديكتاتور التي تحمي الأقليات وخصوصاً “المسيحية”، سينسى القارئ في الغرب مباشرة الديكتاتور، ويتعامل مع فكرة حماية الأقليات لأنها أهم بكثير بالنسبة إليه، وبالطبع سينطبق ذلك الحكم العلماني على الابن بشار، فيما لم يتطرق البحث إلى الانتهاكات الواسعة ضد المسيحيين وباقي الأقليات، بل ضد العلويين ذاتهم ممن وقفوا ضد الأسد، بل ضد الأحزاب العلمانية على وجه الخصوص والتي عاملها الأب والابن بقسوة ووحشية أكبر من تلك التي تعامل بها مع الأحزاب الإسلامية، وهو أمر معروف وموثق.
وفي نقطتين شديدتي الحساسية، يضعنا البحث في مواجهة حالة من التزييف المتعمد والممنهج ودون مواربة، وذلك حينما يتحدث عن المظاهرات في درعا عام ٢٠١١، فهو يروي بالضبط ما حدث، أسباب المظاهرات وقصة أطفال درعا الذين كتبوا على الجدران، ولكنه يصف درعا بأنها من “أفقر” المناطق في سورية، قد نستطيع هاهنا تفسير ذلك بخطأ في المعلومات، حيث يعرف الجميع أن درعا هي من أغنى المناطق في سورية، ولكن توصيف درعا بالمحافظة الفقيرة جاء مقصوداً تماماً ليقول بأن ثورة السوريين كانت بسبب الفقر، وليست ثورة كرامة وحرية، قد نخطئ هنا في قراءة النوايا، وقد نتجنى على البحث، غير أن ما سيأتي لاحقاً سيكشف الوجه الحقيقي للتوجه والأهداف التي يريد الوصول إليها، فهو يقول في الفقرة التالية بأن آلافا من “المسلمين” في درعا خرجوا في مظاهرات تطالب بإخلاء سبيل الأطفال المحتجزين، وهذا التوصيف في منتهى الخطورة، فأهالي درعا خرجوا في مظاهرات باعتبارهم مواطنين لا باعتبارهم مسلمين، والفارق بين الكلمتين كبير جداً، ولكن استخدام هذا التوصيف بالإضافة إلى وصف درعا بالإقليم الفقير، يحمل رسالة محددة الهدف واضحة المعالم للمجتمع الغربي، بأن الثورة في منشئها كانت ثورة فقراء وثورة إسلاميين، وهو بالضبط ما روجه الأسد وراهن عليه لسحب تعاطف الغرب مع ثورة السوريين والتضييق عليها وخنقها إن أمكن.
يتبع….