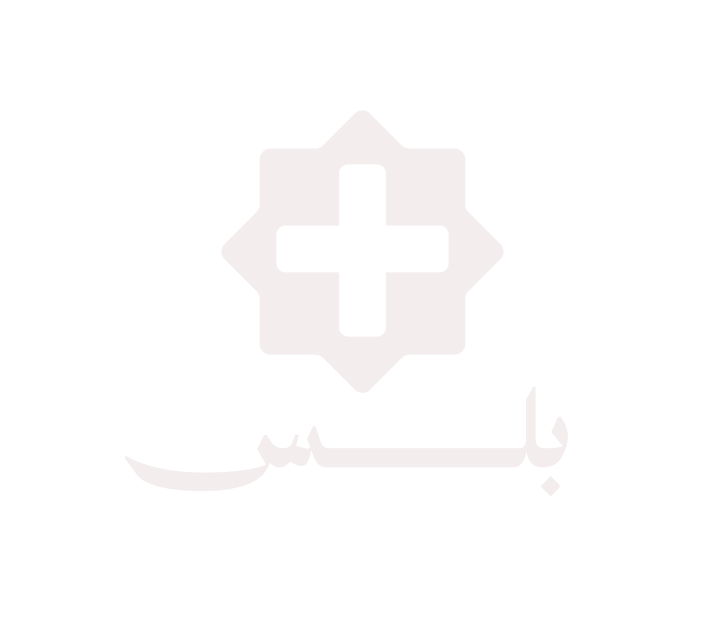تعذيب نفسي وجسدي، ظلم وقهر، كل هذا جزء ضئيل من ما نقل عما يجري في غياهب السجون، معتقلات النظام السوري فاقت في ظلمها كل حدود الفظاعة التي شهدتها الإنسانية على مر العصور، وهذه فظاعات تجاوزت حدود السجن وجدرانه لتصل إلى محاكم النظام الصورية، وهو أمر غير مستغرب على نظام يعتبر طفلاً يحلم بالحياة إرهابياً يستحق القتل، ويعتبر قتله واغتياله نصراً وبطولة.
صفاء الطفلة الشابة ابنة العشرين ربيعاً، قضت منها ثلاثة سنوات في أقبية السجون والمعتقلات، دون أن تدري ما تهمتها الوحيدة، فكل فرع يكيل لها جملة من التهم لتنقل إلى آخر فيعيد سرد ذات الديباجة السمجة والقذرة التي مارسها سلفه وينهيها بإنجاز عظيم، وهو اختراع تهم جديدة تزيد من سماكة ملف قضية صفاء.
آخر مسرحيات النظام بحق صفاء كانت في سجن عدرا ضمن قائمة من آلاف المعتقلات كل منهن لديه قصته ومأساته.
لم تكن صفاء لتختلف عن بقية نزيلات فندق عدرا الأسدي سيء الصيت، لكن ما ميزها هي نقطة تحول في حياتها قلبتها رأساً على عقب وتحولت إلى صفاء أخرى.
كان ذلك اليوم الذي لن أنساه ما حييت لحظة أن أدخلت صفاء برفقة أخريات إلى مهجعنا بعد أن تم عرضهن على ما يسمى بالمحاكم العسكرية الميدانية، ليتبين لها أن السيناريو الذي تفتق عنه ذهن المحقق الجهبذ ومخرج العرض المسمى مجازا بقاضٍ، أنهم أعطوها دور البطولة في الميتافيزيقيا الأسدية لروايتهم، فأصبحت صفاء وهي بعمر السادسة عشر مسؤولة عن تفجير عدة حواجز لقوات نظام الأسد ومتهمة بقتل العشرات إن لم يكن المئات من عناصره وشبيحته (أعلم جيداً أنك الآن يا من تقرأ هذه الكلمات شعرت بنوع من السخرية من هكذا نص وهكذا تهمة لا يصدقها عاقل أو رشيد)، نعم لست أنت وحدك عزيزي القارئ، صفاء هي الأخرى ما أن سمعت بتهمتها وعلمت أنها أصبحت تعد الأيام وتودع الدنيا وهي النتيجة المحتومة لكل من يمر بجزار المحاكم الميدانية.
دخلت صفاء في حالة يمكن أن ندعوها إنكاراً للواقع ورفضاً له كونها أضعف من أن تدافع عن نفسها أمام جلاديها، ولا تملك وسيلة لتغير مصيرها، فدفعها الواقع الذي تعيشه إلى الهروب إلى واقع آخر عله يكون أقل إيلاماً ووحشة، فراحت تتصرف بحالة هي أقرب إلى الجنون منها إلى العقلانية، فقامت بقص شعرها لتجعله قصيراً كالصبيان وراحت تهذي بكلمات وعبارات غير مترابطة المعنى، فتراها أحيانا تغني في الليل والناس نيام وتبتسم لحدود القهقهة بصوت عالٍ دون أن يخاطبها أحد.
قد يتساءل البعض وماذا في ذلك، السجناء تلجأ للغناء والضحك أحيانا لتروح عن نفسها، أقول لهم هذا يصح في حال كان الغناء أو القهقة أو أي تصرف من هذه التصرفات مسموحاً في عدرا، فنحن المعتقلات كنا نخفي أصوات ضحكاتنا التي تخرج أحيانا بين الفينة والأخرى خوفاً من العقوبة التي تنتظرنا من آمر المعتقل وعقيده الذي لا تعرف هراوه معنى الرحمة أو الشفقة وكم من مرة انهالت هذه الهراوة على جسد صفاء النحيل، أو سيقت من شعرها قسراً لترمى في ظلمة منفردة لا لشيء، فقط لأنها تغني وتضحك بصوت عالٍ، ويبدو أن ممارستنا بما تبقى لدينا من هامش الإنسانية كان يزعج السجانين، لهذا كنا نحن الأسوياء نفسياً إن صح أن يطلق علينا أسوياء، ننصحها لصفاء مراراً بعدم استفزاز السجان وأن تلتزم كما نحن بضوابطه خوفاً منا عليها من العقوبة التي تنتظرها لا محالة، لكن في كل مرة كانت تهز رأسها بأنها استوعبت النصيحة وما هي إلا فترة قصيرة حتى تعاود سيرتها الأولى ونظل نحن البقية نرقب سماع خطوات السجانين وهم يتوجهون صوب مهجعنا لإسكاتها بطريقتهم السادية.
ألم يكن يكفي عذابا لصفاء أنها محرومة من زيارات ذويها أو أي فرد من عائلتها، أو حتى إجراء مكالمة مع العالم الخارجي لها طيلة سنوات اعتقالها، ولا تعلم إن كانوا ضمن الأحياء أم رحلوا إلى دنيا الأموات، وهم أيضاً لا يعلمون مصير ابنتهم التي ينكر النظام وجود كل من يحال لمحاكمه الميدانية في سجونه، ألم يكفهم ما عانته صفاء من تعذيب وما قاسته من قهر وظلام السجون، لكن يبدو أن سجانها لم يكتفي ولم يرضي نرجسيته ولا نهمه الدموي بل أراد أن يتفنن في رسم معالم نهاية سوداء لا يجاوزها في قتامتها سوى ظلام وسواد قلوب جلاديها أنفسهم.
ودعت صفاء بعد مغادرتي لسجن عدرا، صراحة لست أعلم ما حل بها من بعدي، ولكني ما زلت أمني النفس بأن يكتب لها النجاة من هذا الجحيم، هي وبقية زميلاتي من معتقلات ومعتقلين كما كتبت لي أنا.