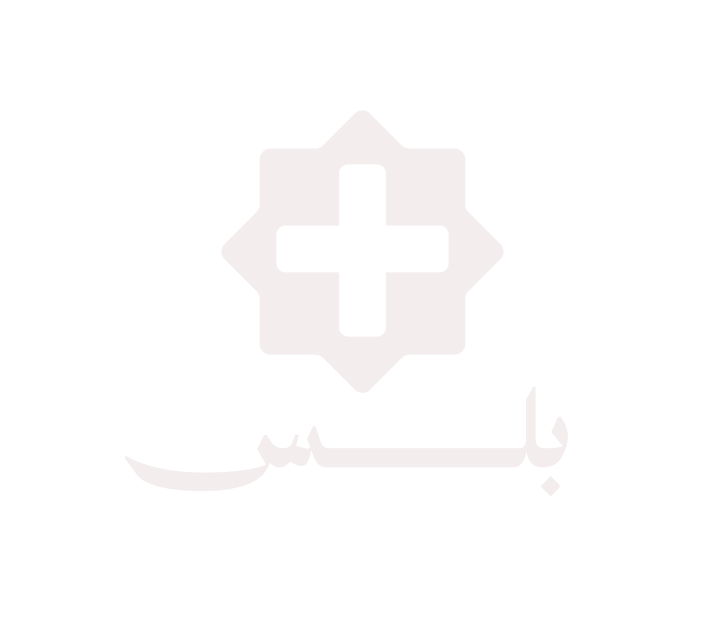تواردت الأخبار عن احتفالات تشبيحية في دمشق مع إتمام اتفاق على تهجير ما تبقى من غوطة دمشق عدا دوما التي يبدو مصيرها مجهولًا. كما تسربت أخبار عن إطلاق الألعاب النارية والرصاص في الهواء احتفالًا بانتهاء الحرب.
يبدو المشهد شديد السوريالية، لاسيما أن ما سبقه بيوم واحد هو قصف على مركز العاصمة، أوضح شهود عيان أنه تم من طائرات. كما يبدو غير منسجم مع وجود مناطق واسعة من البلاد خارج سيطرة النظام، ومع وجود قوات دولية تبدأ بقوات التحالف الدولي وروسيا ولا تنتهي بميليشيات متعددة الطوائف والجنسيات، إلا أن هذا المشهد منسجم تمامًا مع ما عمل عليه النظام ليس منذ لحظة انطلاق الثورة السورية وإنما منذ لحظة وصول الأسد الأب إلى السلطة.
عمل النظام السوري بدأب وإصرار على تفكيك مفهوم المواطنة، فانتمى سكان هذه الرقعة الجغرافية المسماة سوريا إلى مختلف الانتماءات قبل انتمائهم إلى وطن، فتقدم الانتماء الديني والطائفي والقومي والعشائري والعائلي على أي انتماء آخر.
انطلقت الثورة السورية بشكلها السلمي، لتحرر المشاركين فيها من هذه المفاهيم الضيقة وتعيد ترتيب انتمائهم للوطن وللمواطنة المتساوية، وتكررت شهادات الناشطين الشباب التي أوضحوا فيها أنهم لم يشعروا بالانتماء إلى سوريا قبل اندلاع الثورة. تشكل لدى الثوار أثناء انخراطهم في الثورة مفهوم عن وطن جامع، يتألم لألم كل بقعة منه ويفرح لفرح أي من أبنائه.
عجز أولئك الذين لم ينخرطوا في الحراك الثوري عن فهم هذه الروح الوطنية التي تجلت في أغنيات وهتافات الثورة، ولعل أبرز النماذج على الخطاب الوطني الجامع هو فيديو جمعة سقوط الشرعية في دير الزور، حيث يقف شاب على منصة ويتجمع حوله عدد كبير من المتظاهرين يرددون وراءه شعارات توضح أهداف الثورة وتعدد المناطق السورية منطقة تلو الأخرى.
امتاز جمهور الثورة بأنه ملون، كما في أي وطن حر، يتدرج من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ويختلف سياسيًا وأيديولوجيًا على أكبر التفاصيل كما على أدقها، فيما ظل الموالون تحت مظلة لون واحد، وإيديولوجيا واحدة لا تسمح بأي تعدد، وكلما ضاق ذاك اللون واختصر بشخص بشار الأسد، كلما ضاق الانتماء لسوريا، ولم يكن غريبًا في ظل ذلك أن تنطلق دعوات “للتخلي” عن مناطق وفي حالات قصوى “لإبادتها.”
إن تحليل مظاهر الفرح – التي لا يمكن تعميمها على سكان دمشق- يمكن أن يتجاوز كل ما سبق، وأن يعزو كل ما جرى إلى فكرة بسيطة: فرح دمشق سببه توقف القذائف التي كانت تقصف بها المدينة. كما أن المبرر الآخر الشائع هو أن الناس في العاصمة تعبوا وأنهكوا وهم بحاجة إلى بصيص من الأمل. وهذا حق لأي مواطن، أن يشعر بالأمان في بلده، وأن يرغب بانتهاء حرب طاحنة، ولكن الغريب فيه هو إنكار نفس المشاعر على آخرين يقاسمهم نفس الوطن، وربما لا يبعدون عنه أكثر من كيلومترين اثنين جغرافيًا.
تمزق النسيج الوطني بعمق، وقد قام النظام مرارًا وتكرارًا بتصوير “احتفالات النصر” في عدد من المدن السورية، إعمالًا في تضخيم الصدع المجتمعي. واليوم، نجد أنفسنا كسوريين أمام سؤال يتكرر كثيرًا في الأوساط الثورية: كيف سيجمعنا يومًا وطن واحد؟
لا تبدو أوساط الموالاة مشغولة جدًا بهذا السؤال، لأن انعدام حس المواطنة يجعل الإجابة سهلة وقد قالها لي أحدهم يومًا: “هاد الحاضر، واللي مو عاجبه يفرقنا ويترك البلد ويمشي.”
كلما اتسعت الهوة الأخلاقية بين من فهم معنى المواطنة ومن يصر على تجاهله، كلما تعقدت إمكانية إيجاد هوية وطنية جامعة يمكن للسوريين أن يبنوا على أساسها وطنًا. ومن المفهوم والواضح أن النظام لا يعبأ بهذه الأسئلة، ولا يعتبر الوطن واحدًا منذ البداية، إذ لا يمكن اعتبار محافظة دير الزور على سبيل المثال محافظة كدمشق وريفها تحت حكم نظام الأسد سواء الأب أو الابن حتى قبل اندلاع الثورة.
من المؤلم حقًا أن معنى المواطنة الحقيقية سيظل حبيس قلوب أولئك الذين قتلوا أو شردوا في المنافي أو الذين تركوا لمصيرهم في مجابهة سلاح أقوى منهم، فيما يجبرون على تلقي أخبار المحتفلين بانتصار لا ينقصه سوى وطن وشعب وأرض.