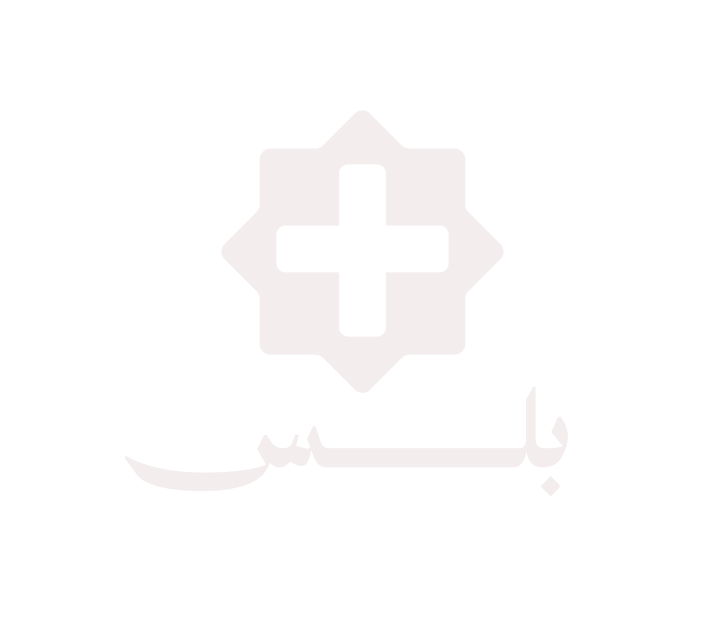في الأسابيع الأولى للثورة، وكنت أعيش في مدينة ادلب، اتصل بي أحدُ البعثيين القدامى، وهو صديق شخصي لي، وقال إنه يريد أن يزورني في البيت.
قلت له: أهلاً وسهلاً.
فلما حضر عرض عليَّ فكرة غريبة جداً، وهي: إقامة مناظرة علنية، في مسرح المركز الثقافي بإدلب، يشارك فيها هو، بوصفه ممثلاً لحزب البعث، وأنا، بصفتي محسوباً على الثورة والمعارضة السياسية. ولم يخفِ عني أنه عَرَضَ الفكرة على الرفاق في قيادة فرع حزب البعث، وقال إنهم وافقوا عليها، ووعدوا بتوفير ما يلزم من إجراءات أمنية لحماية المكان، وسلامة الحاضرين، مع التأكيد على فكرة أنهم سوف يتقبلون رأيي وآراء الحاضرين في القاعة، حتى ولو أبدى بعضُهم ملاحظات ضد “النظام”.
قلتُ له: أنا موافق، ولكن شريطة أن نجري أنا وأنت الآنَ مناظرة مبكرة، مكانها هنا، في هذا البيت، ومن دون جمهور. وبعدها إما أن نكتفي بما نقوله نحن الاثنين، أو نتابع في المركز الثقافي كما تقترح أنت.
قال: لا مانع.
قلت: وإذا سمحت لي أن أبدأ أنا الكلام.
قال: تفضل.
قلت له: أنا مواطن سوري، مقيم في هذا القُطر الصامد منذ ولادتي في ربيع سنة 1952، لم أغادره إلا قليلاً، وأعيش، مع الأسف الشديد، شبهَ مجرد من أبسط حقوقي الاعتبارية. صحيح أنني لم أدخل سجناً أو معتقلاً، ولكن هذا لا يعني أن نظامكم جيد، وديمقراطي، لا يتدخل في الحرية الشخصية للمواطن السوري، ولا يحكم البلاد بموجب قانون الطوارئ والأحكام العرفية.. ببساطة: أنا لم أعتقل لأنني جبان! أعرف كم هو كبير حجم الإجرام الذي يُمَارَسُ بحق المواطنين السوريين في أقبية التوقيف التي توجد في فروع أمن الدولة، والأمن السياسي، والأمن العسكري، والأمن الجوي، وفرع فلسطين، ثم في السجون الرهيبة التي يُساق إليها المعتقلون زرافات ووحداناً، على نحو يومي، ويأتي في مقدمتها، من حيث الفظاعة، سجنُ تَدْمُر. وبسبب هذه المعرفة، ولأنني إنسان رقيق القلب والمشاعر، فقد تنازلتُ عن حقي في الانتساب إلى الأحزاب السياسية الحقيقية التي تنازعتني، أكثر من مرة، رغبةٌ قوية للانتساب إليها، كحزب العمل الشيوعي الذي انتسبَ إليه عددٌ لا بأس به من أصدقائي، وذاقوا في معتقلات حافظ الأسد ووريثه الويلات. وفي أوائل الثمانينات، حينما تفتحتْ موهبتي الأدبية (كما تتفتح البراعمُ في الربيع وتكتسي الطبيعةُ برداء سندسي) لم أجد من الرفاق البعثيين، أيَّ تضامن معي، أو تشجيع لي، بل حصل عكس ذلك، إذ بدأت العيون تلاحقني، وتَضِيْقُ مما أحققه من نجاحات في عالم الأدب، حتى إن أحد الرفاق البعثيين اتصل برئيس القسم الثقافي بجريدة تشرين (كما علمتُ في إحدى زياراتي للجريدة) وعَرَّفَهُ على نفسه بأنه رفيق ذو سجل حافل بالنضال ضد الإمبريالية، وعاتبه لأنه لم ينشر له أيَّاً من المقطوعات النثرية الثلاث التي أرسلها إليه منذ أكثر من شهر، بينما الجريدة تنشر مقالات هذا (الشيوعي) خطيب بدلة! فضحك رئيس القسم وقال له: الأمر غاية في البساطة، تَعَلَّمْ أنت الكتابةَ من هذا الشيوعي، وأرسل لنا مقطوعاتك لننشرها لك!
بالمناسبة: أنا لم أكن منظماً في أي حزب شيوعي، ولكن، ولأنني ذو نَفَس يساري اشتراكي فقد التصقت بي هذه التهمة، والشيء الطريف هو أن فرع الأمن السياسي بإدلب بقي محتاراً في معرفة ما إذا كنتُ شيوعياً بكداشياً، نسبة إلى خالد بكداش، أم فيصلياً، نسبة إلى يوسف فيصل، أو إلى حزب العمل. وذات مرة قال لي الرائد أحمد، المسؤول عن مكتب التحقيق في فرع الأمن السياسي بإدلب:
– أنت، والله، محيرنا، فالتقارير التي تأتي من دمشق تقول إنك من حزب العمل الشيوعي، وأما دراساتنا المحلية فتقول إنك شيوعي بكداشي، وتعمل مراسلاً لنشرة “نضال الشعب” في إدلب. قالها ببراءة، مما يدل على أنه لا يعرف أن حزب العمل والحزب الشيوعي البكداشي متنافران، لا يطيق أحدُهما الآخر.
خلاصة: لم يشأ صديقي البعثي تقديم ما لديه من حجج لإقناعي بالاشتراك في المناظرة، ربما لأنني نجحت في قطع الطريق عليه.. أو ربما أنه تخلى عن فكرة إقامة المناظرة معي لخشيته من أن أقدم له مزيداً من الوقائع التي تدين نظامه وحزبه، وما أكثرها.